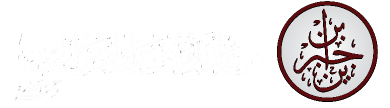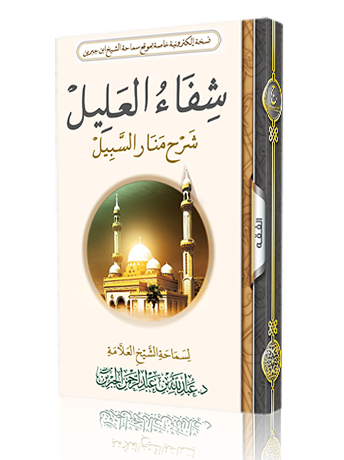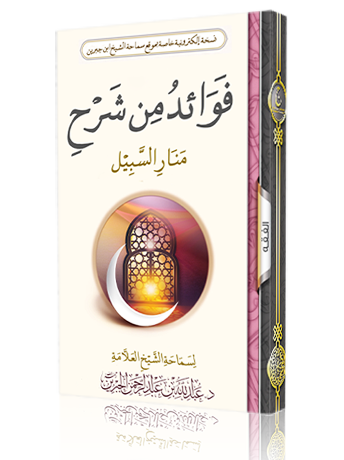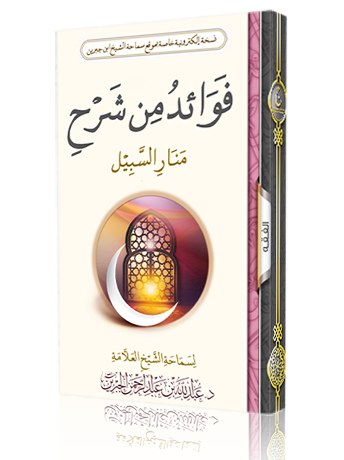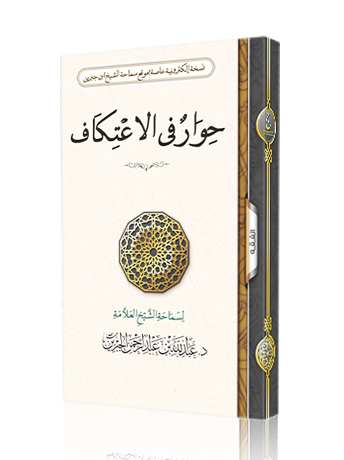شفاء العليل شرح منار السبيل

المطلب الثاني: سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد وكثرة الاختلاف عنه
إنك بعد أن تقرأ في المطبوع من مسائل أحمد التي أشرنا إليها آنفا، يتضح لك حرص أولئك التلاميذ على الأخذ عن هذا الإمام، وبحثهم عن قوله في الوقائع أو في المسائل التي يقدر وقوعها؛ ليستفيد الطالب من أستاذه، ويعرف ما لديه في هذه المسائل التي لا يحضره دليلها، أو تختلف فيها عنده الآراء، وتعرف أيضا دقة السائل في التعبير عن ما أشكل عليه، ونظرا لتوافق الأجوبة وتقاربها في الصياغة يتضح أن السائل أثبت عبارة شيخه كما سمعها دون تغيير فيها غالبا.
ثم إن هذا الإمام عرف بتورعه وتحريه في الجواب، وتوقفه في الفتوى وعدم تسرعه، تحرجا وتخوفا من القول على الله بلا علم، فإن أغلب ما ينقل عنه من العبارات في الممنوع: لا ينبغي هذا، أو لا يصلح، أو أنا أستقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه، أو أكره ذلك، أو لا يعجبني، أو لا أحبه، أو لا أستحسنه، وهكذا يقول في المطلوب: هذا أحب إليّ أو أعجب، أو أنا أحب هذا، أو هذا أحسن، أو ما أحسنه، أو لا بأس به، أو أخشى أو أخاف أن يكون كذا، أو لا يكون، أو يجوز أو لا يجوز، ونحو ذلك، فأما التصريح بالإيجاب، أو التحريم فقليل في الرواية عنه إلا مع قوة الدليل، ولعله يستحضر دائما قول الله تعالى:  وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  الآية.
الآية.
ثم هو كثيرا ما يجيب على الأسئلة بالنص الصريح في الحكم من آية أو حديث، اكتفاء بإيراده عليها عن البت فيها بحكم، وقد يقتصر على ذكر جواب من سبقه فيها من صحابي أو تابعي مما يكون رمزا لاختياره  ولعل هذه الأمور أسباب كثرة الأقوال وتعدد الروايات عنه في المسألة الواحدة؛ حيث يروى عنه أحيانا ثلاث روايات أو أكثر، وقلّ أن توجد مسألة مجالها الاجتهاد، أو فيها اختلاف إلا وعنه فيها روايتان فأكثر، ثم إنه يفتي في كل وقت بما يناسبه كعادة المجتهد، أو بما يناسب السائل ويطابق حالته، فالبعض يناسبه التخفيف والرخصة، بينما يناسب آخر التغليظ، أو ذكر الحكم الصريح، كما أن المفتي قد يحضره دليل للمسألة أو يترجح عنده في بعض الأحيان، وفي حين آخر يغيب عنه ذلك الدليل، أو يظهر له ضعف دلالته، فتختلف الأجوبة بهذه الأسباب، مما يسبب كثرة الروايات التي يظنها المتأخر متباينة، فينقلها كأقوال لذلك الإمام وحده، مع إمكان الجمع بينها أو تداخلها، ولا شك أن أسباب هذا الاختلاف جليّة.
ولعل هذه الأمور أسباب كثرة الأقوال وتعدد الروايات عنه في المسألة الواحدة؛ حيث يروى عنه أحيانا ثلاث روايات أو أكثر، وقلّ أن توجد مسألة مجالها الاجتهاد، أو فيها اختلاف إلا وعنه فيها روايتان فأكثر، ثم إنه يفتي في كل وقت بما يناسبه كعادة المجتهد، أو بما يناسب السائل ويطابق حالته، فالبعض يناسبه التخفيف والرخصة، بينما يناسب آخر التغليظ، أو ذكر الحكم الصريح، كما أن المفتي قد يحضره دليل للمسألة أو يترجح عنده في بعض الأحيان، وفي حين آخر يغيب عنه ذلك الدليل، أو يظهر له ضعف دلالته، فتختلف الأجوبة بهذه الأسباب، مما يسبب كثرة الروايات التي يظنها المتأخر متباينة، فينقلها كأقوال لذلك الإمام وحده، مع إمكان الجمع بينها أو تداخلها، ولا شك أن أسباب هذا الاختلاف جليّة.
وقد ذكر ابن القيم في أول المجلد الثالث من (إعلام الموقعين) أمثلة كثيرة لاختلاف الفتوى باختلاف الأوقات والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد، وأن المنع يناسب في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص، ويناسب الترخيص أو التوسع في حين آخر، أو لشخص مغاير  فإن المفتي كثيرا ما يعتبر حالة السائل وضرورته إلى التخفيف في المسألة التي لا يوجد فيها نص قاطع، فيجتهد ويفتيه بما هو أخف وأسهل في حقّه، كما أنها قد تتعارض عنده الأدلة ظاهرا، فيقتصر على ذكر الحديث أو الأثر الفلاني، ويترك ذكر ما عارضه، فينقل السامع ذلك مذهبًا، كما أنه قد يترجح عند المفتي أحد الدليلين في وقت من الأوقات فيقول به، ثم تجري المسألة في وقت آخر فيترجح فيها الدليل الثاني فيقول به، كما أن الجواب قد يقصد به موافقة القائلين به من العلماء الأكابر، وإن خالف نصا مؤولا، قال الجمهور بخلافه، كما أن كثيرا من الرواة قد يخطئ في النقل أو يقع منه وهم أو سهو، أو عدم فهم للجواب، فيخطئه العلماء، ويكون شذوذه ومخالفته للجمهور في نقل جواب هذه المسألة مبررا للجزم بتخطئته، فلهذه الأسباب وغيرها كانت الروايات في مذهب أحمد -رحمه الله- أكثر من سائر الأئمة، فإن الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- أثبت في أثناء موطئه ما يقوله به ويختاره في المسائل والوقائع، وكتب بقية ما يتعلق بمذهبه الإمام سحنون عن ابن القاسم في المدونة، وكذا الشافعي -رحمه الله- فإنه كتب الكثير من الرسائل في مواضيع شتى، وكتب عنه تلامذته كالربيع و البويطي و المزني بقيتها، فأصبحت اختياراته مثبتة محصورة لا يوجد فيها اختلاف إلا قليلا، أما أبو حنيفة -رحمه الله- فهو أقدم الأئمة، وقد اشتهر بفقهه وفهمه، وتعليله لما يقوله، ولم يكتب شيئا من أجوبته ولا اختياراته
فإن المفتي كثيرا ما يعتبر حالة السائل وضرورته إلى التخفيف في المسألة التي لا يوجد فيها نص قاطع، فيجتهد ويفتيه بما هو أخف وأسهل في حقّه، كما أنها قد تتعارض عنده الأدلة ظاهرا، فيقتصر على ذكر الحديث أو الأثر الفلاني، ويترك ذكر ما عارضه، فينقل السامع ذلك مذهبًا، كما أنه قد يترجح عند المفتي أحد الدليلين في وقت من الأوقات فيقول به، ثم تجري المسألة في وقت آخر فيترجح فيها الدليل الثاني فيقول به، كما أن الجواب قد يقصد به موافقة القائلين به من العلماء الأكابر، وإن خالف نصا مؤولا، قال الجمهور بخلافه، كما أن كثيرا من الرواة قد يخطئ في النقل أو يقع منه وهم أو سهو، أو عدم فهم للجواب، فيخطئه العلماء، ويكون شذوذه ومخالفته للجمهور في نقل جواب هذه المسألة مبررا للجزم بتخطئته، فلهذه الأسباب وغيرها كانت الروايات في مذهب أحمد -رحمه الله- أكثر من سائر الأئمة، فإن الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- أثبت في أثناء موطئه ما يقوله به ويختاره في المسائل والوقائع، وكتب بقية ما يتعلق بمذهبه الإمام سحنون عن ابن القاسم في المدونة، وكذا الشافعي -رحمه الله- فإنه كتب الكثير من الرسائل في مواضيع شتى، وكتب عنه تلامذته كالربيع و البويطي و المزني بقيتها، فأصبحت اختياراته مثبتة محصورة لا يوجد فيها اختلاف إلا قليلا، أما أبو حنيفة -رحمه الله- فهو أقدم الأئمة، وقد اشتهر بفقهه وفهمه، وتعليله لما يقوله، ولم يكتب شيئا من أجوبته ولا اختياراته  وإنما كتبها صاحباه أبو يوسف و محمد بن الحسن اللذان تتبعا أجوبته في حينها، واستوعب كل منهما ما ظفر به منها، فقل الخلاف عنه، بخلاف تلامذة الإمام أحمد فإنهم لم يجرؤوا على كتابة أقواله أمامه إلا ما ندر، حيث منعهم من تقليده وأمرهم أن يأخذوا من حيث أخذ، ولكن بعد أن اشتهر بالفضل والورع، وبعد أن رأوا كثرة من يجله ويحترمه ويحبه ويرغب في القول بما يقوله، ويبحث عن أجوبته واختياراته، فلا جرم كتب عدد كثير منهم ما حفظه واستحضره واستظهره من تلك الأجوبة، فمن ثمّ وقع الاختلاف الكثير بينهم، للأسباب التي ذكرناها آنفا، وإذا كان قد وقع خطأ من فرد منهم، فإنه نادر وقليل جدا، وسببه الاعتماد على الذاكرة، مع طول العهد بالكلام المسموع، وكثرة الأسئلة أو عدم الفهم للسؤال، أو فوات بعض الجواب أو نحو ذلك، وإلا فليس أحد من أولئك الرواة متهما بالقول عليه أو التخرص في الكتابة عنه، فما منهم إلا من هو عالم شهير، موصوف بالديانة والصيانة، والصدق والعلم، والحرص على الاستفادة، وأنه من أخص تلاميذ الإمام أحمد وأقربهم منه، وأكثرهم له ملازمة، وما إلى ذلك، كما في تراجمهم في الطبقات وغيرها، والله أعلم.
وإنما كتبها صاحباه أبو يوسف و محمد بن الحسن اللذان تتبعا أجوبته في حينها، واستوعب كل منهما ما ظفر به منها، فقل الخلاف عنه، بخلاف تلامذة الإمام أحمد فإنهم لم يجرؤوا على كتابة أقواله أمامه إلا ما ندر، حيث منعهم من تقليده وأمرهم أن يأخذوا من حيث أخذ، ولكن بعد أن اشتهر بالفضل والورع، وبعد أن رأوا كثرة من يجله ويحترمه ويحبه ويرغب في القول بما يقوله، ويبحث عن أجوبته واختياراته، فلا جرم كتب عدد كثير منهم ما حفظه واستحضره واستظهره من تلك الأجوبة، فمن ثمّ وقع الاختلاف الكثير بينهم، للأسباب التي ذكرناها آنفا، وإذا كان قد وقع خطأ من فرد منهم، فإنه نادر وقليل جدا، وسببه الاعتماد على الذاكرة، مع طول العهد بالكلام المسموع، وكثرة الأسئلة أو عدم الفهم للسؤال، أو فوات بعض الجواب أو نحو ذلك، وإلا فليس أحد من أولئك الرواة متهما بالقول عليه أو التخرص في الكتابة عنه، فما منهم إلا من هو عالم شهير، موصوف بالديانة والصيانة، والصدق والعلم، والحرص على الاستفادة، وأنه من أخص تلاميذ الإمام أحمد وأقربهم منه، وأكثرهم له ملازمة، وما إلى ذلك، كما في تراجمهم في الطبقات وغيرها، والله أعلم.